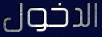الإسلام.. بدأ غريبا وسيعود غريبا!
سلمان العودهعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل، إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي". رواه الترمذي.
جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: قوله: "إن الدين ليأرز" بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زاي. وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء، وقال إن الكسر هو الصواب. وحكى أبو الحسن بن سراج ضم الراء ومعناه ينضم ويجتمع.
"إلى الحجاز": وهو اسم مكة والمدينة وحواليهما في البلاد، وسميت حجازا لأنها حجزت أي منعت وفصلت بين بلاد نجد والغور. وفي حديث ابن عمر عند مسلم: "إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها". وهذا يعني أنه كما كان الحجاز مركز الدعوة الإسلامية في حياة

صلى الله عليه وسلم فكذلك سيصبح الحجاز مركز إحياء الدين الإلهي حين يختفي أثره من حياة الناس. فالحج مقام العبادة الإلهية كما هو مركز الدعوة إلى دين الله وتجديده؛ وتقتضي الحاجة أن نحيي الحج ومركز الحج مرة أخرى من هذه الناحية.
إن الغربة الواردة في هذا الحديث هي جزء من الغربة التي كون المرء على حال من الاستقامة العلمية والعملية يقل موافقوه فيها، ويكثر مخالفوه وشانئوه، وإذا دعا الناس إلى ما هو عليه قل متبعوه، وهذا ما يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الغرباء: "أناس صالحون، في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم".
وهذا وجه من وجوه الغربة يتمثل في قلة المعين على الخير، وقلة المستجيب لدعوة الله. وثمة وجه آخر، وهو المشقة التي يجدها السالك في التزام الصمت وفي تجنب العثرة، فإنه كلما بعد عهد الناس بالنبوة، زاد الشر وقل الخير، وكثرت المفاسد وقلت المصالح وأصبح من العسير تحصيل المصلحة إلا ومعها قدر من المفسدة..
وإذا كانت هذه الغربة جزءا من معنى الغربة العام، فإنه يمكن تقسيم المعنى العام للغربة إلى صورتين:
الأولى: غربة أهل الإسلام في أهل الأديان، في كل زمان ومكان، فالمسلمون في الكفار هم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الدابة. إنهم قليل؛ قال الله تعالى "وقليل من عبادي الشكور".
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فقال: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر".
وهذه الحقيقة الثابته، شرعاً وقدراً، وهي قلة المؤمنين في جنب الكفار توجب للمسلم نظرة متوازنه معتدله: فالذين يطمعون في تطهير الدنيا من الكفر والشرك مثاليون ومغرقون في التفاؤل، بل لا يزال الصراع بين التوحيد والشرك قائما حتى يأتي أمر الله. والذين يتخذون من هذه الحقيقة تكأة للقعود عن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وبذل الجهد في هذا السبيل مخطئون أيضا، ومتجاهلون للحقائق الواقعية؛ وهذه الحقيقة التي أخبر بها

عليه الصلاة والسلام لم تمنعه ولا أصحابه من الجهر بالدعوة والتضحية في سبيلها، والصبر عليها حتى هدى الله على أيديهم من شاء من هدايته.
الثانية: هي غربة أهل السنة الصابرين عليها، المنتسبين إليها، البراء مما عداها، في أهل الإسلام. غربة هؤلاء في المسلمين قد تكون في كثير من الأحيان أشد من غربة المسلمين في سائر الأديان، وكلما ازداد تمسك هذا الغريب بالسنة، علما وعملا، ازدادت غربته وقل مشاكلوه وكثر مخالفوه، فهو مسافر في طريق طويل، ذي مراحل، ومعه أصحاب، كلما قطع مرحلة انقطع بعضهم، حتى لا يكاد يواصل السير معه إلا القليل.
ويجد هذا الغريب كرب الغربة وشدتها على النفس حين يكون المنابذون له، المسفهون لرأيه، هم من إخوته في الدين!
"وظلم ذوي القربى أشد مضاضة/ على المرء من وقع السهام".
فالمسلم لا يعجب أن يحاربه الكفار، ويضعوا العقبات والأشواك في سبيله، بل العجب لو لم يفعلوا ذلك. لكن أن يكون إخوانه في الدين هم القائمين بهذا الإيذاء.. فذلك الجرح الذي لا يندمل. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: "استوصوا بأهل السنة خيراً، فإنهم غرباء".. وقال: "إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة، وآخر بالمغرب، فابعث إليهما السلام، وادع لهما، ما أقل أهل السنة والجماعة". وقال أبو بكر بن عياش: "السنة في الإسلام أعز من الأسلام في سائر الأديان".
والأمر الذي يقال في موضوع غربة الإسلام في الأديان يقال هنا، فثبوت غربة أهل السنة بين طوائف أهل القبلة لا يسوغ القعود والاستيئاس، بل يجب على أهل السنة أن يعملوا على نشر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح في الاستدلال، والصورة الصحيحة للسلوك بين سائر المسلمين، وأن يكون لهم كيان يرفع رايتهم في كل أرض، وأن يعلنوا مسلكهم بكل وسيلة، بالكتاب والمجلة والمحاضرة والمناظرة، وأخذ زمام المبادرة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام حين ترتسم في عقولهم الصورة الحقيقية عن الإسلام.
إن هذه الغربة التي ستوحد- لا محالة- هي غربة مقيدة تتفاوت بين زمان وزمان، ومكان ومكان، وقد تشتد حتى تضيق عليهم أنفسهم وقد تنفرج حتى يتنفس المؤمنون الصعداء وتقر أعينهم بانتصار للدين والسنة. وهذا الفهم يجعل الغريب مجاهدا في غربته حريصا على دفع الغربة عن الإسلام وأهله، والسنة وأهلها ما استطاع.
ولذلك يجب أن نفرق بين هذه الغربة، وبين الغربة الأخيرة المستحكمة التي تكون قبيل قيام الساعة. إذ إن الغربة الأخيرة هذه لا يكاد يوجد فيها مصلحون ولا دعاة، يعصيهم من الناس أكثر ممن يطيعهم وتعم الغربة فيها أنحاء الارض، حتى تترك المدينة لا يغشاها إلا الهوام.
والغربة المذكورة ثلاثة أنواع:
- غربة شرائع: بحيث تصبح بعض شرائع الإسلام غريبة، كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..
- غربة مكان: وهي أن يكون الدين غريبا في بلد من البلدان ويكون أهله غرباء في ذلك البلد، بينما هم في بلد اخر آعزة ظاهرون، فالغربة تكون في مكان دون مكان.
- غربة زمان: وهي الغربة المستحكمة المطبقة على الأرض كلها بحيث يغدو الدين غريبا في زمن من الأزمنة في بقاع الأرض كلها كما حدث قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا يكون في أمته عليه الصلاة والسلام بعد عهود عيسى عليه السلام وقبل الساعة. أما ان تستحكم الغربة وتعمم الجاهلية الأرض كلها قبل قبض أرواح المؤمنين فهذا لا يكون؛ لذا وعد الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه "لا تزال في هذه الامة طائفة ظاهرة منصورة لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس".