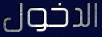أحزان الأحد الدامى وضعتنا فى مأزق التعارض بين صوت العقل وصوت الضمير. لا أعرف عدد الذين يشاركوننى هذا الشعور، لكننى أتحدث عن نفسى على الأقل مسجلا حيرتى إزاء استحقاقات النداءين، ذلك أننى أعتبر نفسى أحد الذين يعتبرون الاصطفاف وراء المجلس العسكرى ضرورة وطنية فى المرحلة الراهنة. وأضع أكثر من خط تحت الكلمتين الأخيرتين، لكى أضفى صفة التأقيت على ذلك الاصطفاف الذى أدعو إليه. ولكى يكون واضحا فى الأذهان أن الالتفاف حول المجلس العسكرى يجب أن يستمر إلى أن يسلم السلطة لمن يختارهم الشعب بديلا مدنيا يقود سفينة الوطن إلى بر الأمان.
لا أخفى شعورا بالامتنان والتقدير للدور الذى قام به المجلس، منذ اللحظة التى أعلن فيها انحيازه إلى مطالب الشعب وثورته. ولن ينسى له أنه بموقفه ذاك أنقذ مصر وشعبها من كارثة التوريث التى كانت تنسج خيوطها منذ سنوات وشارفت بلوغ التمام. بل أنقذ الوطن من براثن العصابة التى اختطفته طوال ثلاثين عاما، وراحت تعتصره وتفترسه لكى تستأثر بأفضل ما فيه.
من ناحية ثانية، فإننى لا أرى فيما هو قائم بديلا عن المجلس العسكرى، وأزعم أن بقاءه بصورته الراهنة وحتى قيام السلطة المدنية المنتخبة، يظل أفضل بكثير من الصياغات البديلة التى يتداولها البعض منذ عدة أشهر، لسبب جوهرى هو أن النظام السابق بعدما قوض خلايا المجتمع الحية حتى أمات السياسة، فإنه طمس معالم الخريطة السياسية للبلد، بحيث لم نعد نعرف من يمثل ماذا، وحتى أصبح الحضور فى الساحة السياسية بعد ثورة 25 يناير قائما على علو الصوت الذى تكفل به الضجيج الإعلامى، إذ صرنا إزاء كيانات ولافتات تملأ الفضاء فى حين لا أثر يذكر لها فى الشارع. وضجيج من ذلك القبيل يصلح لإطلاق مظاهرة وربما حشد مليونية لكنه لا يصلح لإقامة دولة.
أدرى أن شعبية المجلس العسكرى تراجعت بصورة نسبية ولم تعد كما كانت عليها منذ ثمانية أشهر. خصوصا أنه حُمِّل بأوزار وآثار النظام السابق، وما كان بمقدوره أن ينهض بكل أعباء التركة الثقيلة التى ورثها. ولكننى أتحدث عن التحول الجوهرى والاستراتيجى الذى يحسب له غير غافل عن الأخطاء «التكتيكية» التى وقع فيها، والتى اعتبرها دون ذلك التحول مرتبة وأهمية. علما بأن نسبة غير قليلة من تلك الأخطاء وقعت بعدما طالت مدة بقائه فى السلطة، استجابة لضغوط ومطالبات الجماعات السياسية التى اعتبرت الاحتكام إلى الشارع تهديدا لوجودها. الأمر الذى يعنى أن بعض الأخطاء التى وقعت إبان إطالة المدة لا يتحمل مسئوليتها المجلس العسكرى وحده، ولكن تلك الجماعات السياسية شريكة فى تلك المسئولية.
هذه حسابات العقل البارد التى اهتزت عندى يوم الأحد الدامى (9 أكتوبر الحالى).. وكان صوت الضمير هو الذى أحدث تلك الهزة، التى لا أستطيع أن أتجاهلها أو أقاومها. لقد تحولت الصور التى رأيتها لضحايا هجمة المدرعات على المتظاهرين فى ذلك اليوم. وكذلك القصص والروايات المروعة التى سمعتها على ألسنة أهاليهم إلى سياط تلهب الضمير وتعذبه، أما أصوات الملتاعين ونحيبهم فقد كانت من النوع الذى يمزق نياط القلب ويصيب الإنسان بزلزلة تسحق إرادته وتلاحقه بأصدائها السوداء فى الصحو والمنام.
لن أختلف مع من يقول بأن ما رأيناه وسمعناه وقرأناه يعبر عن وجهة نظر واحدة، وأن وجهة النظر الأخرى لم تسمع، كما أن هناك تحقيقات جارية لم تنته بعد. ذلك أفهمه وأقدره، لكننى أزعم أن الذى جرى ما كان له أن يقع تحت أى ظرف. إذ ما تمنينا أن تطيح المدرعات بأى إنسان مهما كان جنسه أو ملته وتدهسه بالصورة البشعة التى طالعناها فى التسجيلات، وما تمنينا أن يتم ذلك بمدرعات الجيش بوجه أخص. وإذا كنا قد عهدناه من جانب أجهزة القمع فى ظل النظام السابق، فإنه يصدمنا ويفجعنا حين يصدر عن الجيش بمكانته العزيزة علينا وهالة المحبة والفخار التى درجنا على أن نحيطه بها. وهى المشاعر الدافئة التى تضاعفت بعد موقفه المشرف من الثورة.
لقد أصبحنا إزاء معادلة صعبة يختزلها السؤال التالى: كيف يستطيع المرء أن يستجيب لنداء عقله ويرضى ضميره فى نفس الوقت؟ ــ أعنى كيف يمكن أن يظل المرء متضامنا مع المجلس العسكرى ومحتفظا بسخطه واحتجاجه على ما نسب إليه من ممارسات؟ ــ فى هذا الصدد لا مفر من الاعتراف بأن الحفاظ على التوازن بين كفتى التضامن والسخط ليس بمقدور كل أحد. وإذا كنت قد اعتبرتها من جانبى معادلة صعبة، فينبغى أن تعذر الشباب إذا ما ضاقت صدورهم إزاء الهول الذى رأوه وسمعوه، فاستبد بهم السخط وما عادوا قادرين على كتمان غضبهم، الأمر الذى أنساهم النصف الملآن من الكوب. لا أعرف ما إذا كان المجلس العسكرى مدركا لذلك التحول أم لا، لكننى لا أخفى أننى صرت أعيشه كل يوم ليس فقط فيما أتلقاه من اتصالات ورسائل، وإنما أيضا لأن أصداءه وصلت إلى أسرتى وصارت تعشش فى بيتى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقالات فهمى هويدى
لم يكن مقنعًا ولا ناجحًا ليتكلم المشير ويعتذر للثقافة (فلول) أيضًا أعطى صوتى لماركو فلوس وفلول