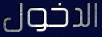«فما بكت عليهم السماء والأرض»
عبد الله بدر المالكيعند فقد الإنسان عزيزاً له لا بد أن تطرأ عليه بعض الآثار النفسية، وقد تتفاوت تلك الآثار نظراً لأهمية ومكانة الشخص المفقود، هذا على المستوى العام الذي يمر به جميع الناس؛ إلا أن هناك نوعاً آخر تختل فيه الموازين وتتغير لفقده الأحوال، ولذلك عبر القرآن الكريم عن فقد هذا النوع بأنه انتقاص للأرض، كما قال تعالى: "أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب" "الرعد 41".
وقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن أحد وجوه تفسير هذه الآية هو موت العلماء أو أصحاب الشأن، ويؤكد ذلك قوله تعالى: "بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون" "الأنبياء 44". وهذا السياق أظهر للمعنى وهو نظير قوله عز وجل: "إنك ميت وإنهم ميتون" "الزمر 30".
وقد نجد أحياناً أن الموازين الأرضية تأخذ المجرى المخالف لنصوص القرآن الكريم، فقد تهرع الناس لموت أهل الضلال أو من يلحق بهم في عرف الأرض، وهذا ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: "يأتي زمان على الناس، الشريف فيما بينهم فاسق والفاسق فيما بينهم مستشرف"؛ وهذه الحسابات الأرضية لا تعادل شيئاً عند الله تعالى، لذلك أشار إلى هذا النوع الهالك بقوله: "فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين" "الدخان 29". وفي الآية مباحث:
المبحث الأول: ذكر جمع من المفسرين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل فيه عمله، فإذا مات فقداه وبكيا عليه، وتلا هذه الآية، ثم قال: وذلك لأنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً صالحاً، فتبكي عليهم، ولم يصعد إلى السماء كلام طيب ولا عمل صالح فتبكي عليهم. انتهى.
المبحث الثاني: يحتمل سياق الآية حذف المضاف ويكون المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض، يعني لم تبكيهم الملائكة ولا المؤمنون، بل إن موتهم جلب السرور لأهل الأرض والسماء، كما هو الحال في موت الطغاة. وحذف المضاف كثير في القرآن كقوله تعالى: "واسأل القرية التي كنا فيها..." "يوسف 82"، أي اسأل أهل القرية. وكذلك قوله: "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها..." "الإسراء 16".
المبحث الثالث: سياق الآية يحتمل المجاز، وهذا من عادة العرب في الكلام فهم في حالة فقدهم للشخص العظيم يقولون بكت السماء وأمطرت دماً، وهذا نوع من المبالغة في تهويل الأمر، كقول جرير:
الشمس طالعة ليست بكاسفة
تبكي عليك نجوم الليل والقمرا.
والآية المبحوث عنها تشير إلى هذا النوع من الذين يستعظمون أنفسهم ظانين أن في حالة موتهم تبكي عليهم السماء والأرض، والأمر ليس كذلك فأنزل منزلة التهكم، كقوله تعالى: "ذق إنك أنت العزيز الكريم" "الدخان 49". ولذلك ختم تعالى الآية بقوله: "وما كانوا منظرين" أي عند مجيء وقت هلاكهم لا يسمح لهم بالتوبة لأن التوبة لا تقبل عند التيقن من الموت لهذا الصنف من الناس، كما قال تعالى رداً على توبة فرعون: "آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين" "يونس 91".
فإن قيل: لماذا لم يقل الله تعالى السماوات بالجمع لأجل أن يكون أبلغ في التهكم؟ أقول: إن ما ظننته هو الصواب بعينه إلا أن النكتة التي لم تحسب حسابها هي أن السماء أكبر من السماوات وليس العكس، لذلك فالتهكم لم يفقد المبالغة، وهذا كقوله: "مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ" "الحج 15".
ولأجل تقريب المعنى إلى الأذهان نحتاج إلى الإطناب في الدليل، يقول تعالى: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين" "آل عمران 133". فهذه الجنة التي أشارت إليها الآية الكريمة وصفت بأن عرضها السماوات والأرض مهما اختلفت الآراء التي قيلت في العرض ومهما كان نوعه، في حين نجد اختلاف العرض في قوله: "سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم" "الحديد 21".
والمتأمل في الآيتين يظهر له أن الجنة المعدة للمتقين لا بد أن تكون أصغر حجماً من الجنة الثانية المعدة للذين آمنوا بالله ورسله لأن أعدادهم أكثر من المتقين، والأولى وصفت بأن عرضها السماوات والأرض، والكبيرة وصفت بأن عرضها السماء والأرض، ولذلك قال في الأولى "وسارعوا" التي تفيد الجري المتقن الذي دأب عليه المتقون دون السباق الذي يقتضي تفاوت المراتب، وقد قال تعالى في المسارعة: "يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير" "ق 44". وقوله "سراعا" يفيد الخروج من الأرض دفعة واحدة بالتساوي لكل من هم بداخلها.
أما في السباق فقد قال: "واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب..." "يوسف 25". والمعنى ظاهر في أن السباق يقتضي أن هناك من يتقدم ومن يتأخر. ولذلك قال في سورة الحديد "سابقوا"، وكأن الأمر فيه نوع من الترغيب في السباق إلى ترك الموبقات التي تلحق الإنسان جراء المعاصي التي تلم به؛ ويؤكد ذلك ذكر الصفات اللاحقة التي ذيلت بها الآيتين، ففي صفات المتقين قال بعد وصف الجنة الخاصة بهم: "الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ.." "آل عمران 134". وهذه الصفات لا تنطبق على من يؤمن بالله ورسله دون التقوى. أما في سورة الحديد فقد ذيل الآية بقوله: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم" فدل على أن هذه الجنة فضل منه تعالى لا عن استحقاق تصاحبه التقوى.
والدليل الآخر على أن الذين في آل عمران أفضل من الذين أشارت إليهم آية الحديد هو مجيء حرف الواو الذي لم يأت في الحديد، وحرف الواو نجده دائماً في القرآن يرافق المتقين، كما في قوله تعالى: "وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ" "الزمر 73". فقوله "وفتحت" جاء مع المتقين فقط؛ أما الذين كفروا فقال "فتحت أبوابها" دون الواو، لأن في الواو خدمة عظيمة للمتقين وقد حرم منها الصنف الآخر.. فتأمل.
وقد كرر حرف الواو أيضاً مع الذين هم على علم بعدد أصحاب الكهف في قوله: "ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم" "الكهف 22". في حين أن القولين السابقين لم يأت فيهما حرف الواو الذي يفصل عددهم عن الكلب. فكل هذا يفيد أن السماء أكبر من السماوات؛ ولذلك فالسماء أعم من السماوات لأن كل ما علاك فهو سماء. ولأجل أن نقرب المعنى أكثر نؤكد ذلك بقوله تعالى: "ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين" "فصلت 11". ثم قال "فقضاهن سبع سماوات في يومين.." "فصلت 12". والمعنى ظاهر في أن السماوات السبع استخرجت من السماء الأصل الذي عين في الاستواء.
لذلك فإن قوله تعالى: "فما بكت عليهم السماء والأرض..." أبلغ في التهكم بعد أن علمت أن السماء أكبر من السماوات. فإن قيل: لماذا إذن جاء قوله: "فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعّال لما يريد" "هود 107". وكذلك في أهل الجنة قال: "وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ" "هود 108".
أكرر لماذا السماوات بالجمع؟ أقول: في هاتين الآيتين أراد سماوات الجنة والنار وأرضيهما والكلام على حقيقته كقوله في وصف يوم الحساب: "يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار" "إبراهيم 48". فالكلام هنا لا يحتمل المبالغة؛ وقد تجد ظهور قدرته تعالى في قوله: "يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين" "الأنبياء 104". ولو كانت السماوات أكبر لذكرت في هذه الآية التي تدل على عظيم قدرته تعالى.
فإن قيل: لماذا لم يجمع الله تعالى الأرض مقابل السماوات التي تأتي معها في الغالب؟ أقول: أينما وجدت الأرض مع السماوات فالقصد أنها الأرضين بالجمع، وقد أشار القرآن الكريم إلى الأرض مجموعة مرة واحدة في قوله: "الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.." "الطلاق 12". وقد ترفع القرآن عن لفظ الأرضين لأنها لغة ضعيفة وغير مستأنسة لدى العرب رغم أنها صحيحة وقد وردت في الأدعية، وهذه من الكلمات التي تجنبها القرآن الكريم، إضافة إلى الآجر، وهو الحجر المستعمل في البناء، فلم يذكره تعالى رغم استعمال العرب له، لذلك قال جل شأنه: "وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين" "القصص 38". فذكر تعالى الطين بدلاً من الآجر.